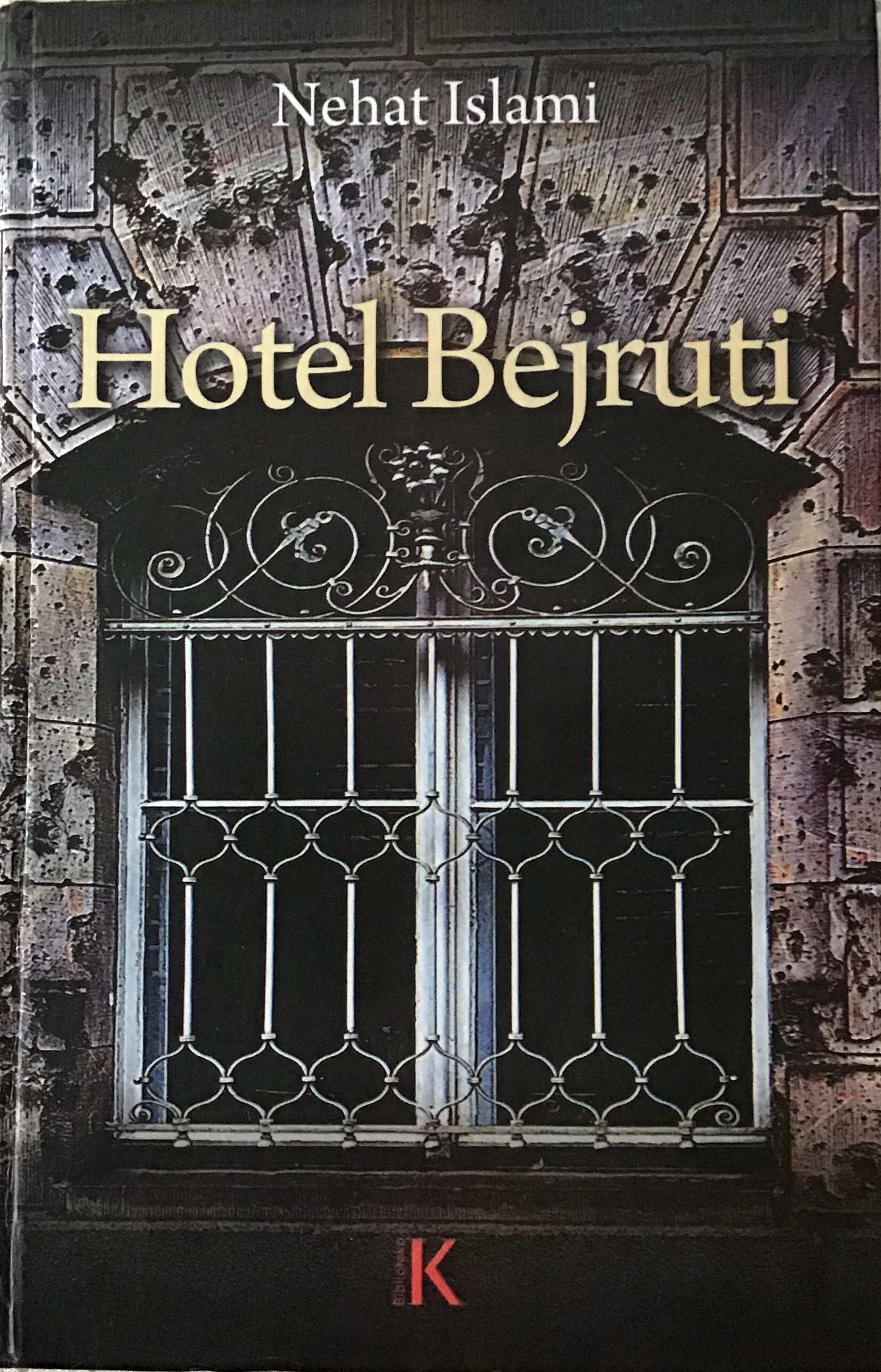الجزء الثاني: قراءة في كتاب «الـمعلقات وعيون العصور» للدكتور سليمان الشطي
أهدى الباحث الكويتي الدكتور سليمان الشطي المكتبة العربية مجموعة متميزة من المؤلفات الإبداعية والنقدية، ومن دراساته النقدية نذكر: «الرمز والرمزية في أدب نجيب محفوظ»، «مدخل:القصة القصيرة في الكويت»، «ثلاث قراءات في نقدنا القديم»«الشعر في الكويت»، «المسرح في الكويت».
وفي كتابه الأخير، الموسوم ب: «المعلقات وعيون العصور»، والصادر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت سنة:2011م، يقدم الباحث الكويتي الدكتور سليمان الشطي دراسة شائقة عن المعلقات الجاهلية، حيث يسعى إلى إبراز مجموعة من الرؤى، والدراسات التي قُدمت عن المعلقات عبر العصور، وكما يصف الدكتور سليمان الشطي دراسته فهي « دراسة للدراسات، ونظرة في النظرات للشعر الجاهلي، المعلقات نموذجاً ومجالاً».
ويشير إلى أن دراسته سعت جاهدة إلى الوقوف مطولاً مع شرح القدماء للقصائد السبع، حيث يرى أن جهودهم مساهمة ثمينة، ومهمة، وأساسية للفهم والتحليل، بيد أنها لم تحظ باهتمام كبير، وعناية فائقة بسبب ما يتبادر إلى العقول من أن جهودهم تنضوي تحت لواء نمط واحد محدود القيمة النقدية.
..نظرات نقدية تراثية
انتقل المؤلف في الفصل الخامس من الكتاب للحديث عن النظرات النقدية التراثية للمعلقات، وفي البدء نبه إلى عدم الانسياق وراء خدعة التصور الأولي الذي قد يوصل إلى المبالغة، كما نوه باحتفال النقد القديم بالمعلقات، وكثرة إيراد النقاد القدامى للأبيات المختارة منها، وذلك لاستخراج بعض المعاني المتميزة، أو تأكيد نظرات مختارة.
وقد كانت النظرات الأولى للمعلقات تنهض على أساس محاولة الفهم الأولي لنصوص تلك القصائد، أي محاولة تفسير النصوص، أو ما يسمى أوليات النقد التفسيري، ومحاولة فك مغاليق النص الأدبي، وذلك ابتداءً من الفهم الحرفي المباشر وصولاً إلى النظرة الأشمل، والإدراك العميق، ثم تجيء بعد ذلك المراحل اللاحقة التي تستخرج الأحكام، والقيم الفنية، وتعقد مقارنات مفيدة، وقد قدم الدكتور سليمان الشطي مجموعة من الأمثلة التي توضح هذا النوع من الملاحظات التفسيرية.
وبالنسبة للنظرة الاجتماعية لفهم الأدب ، فقد تجلت بعض أسسها عند ابن طباطبا العلوي من خلال كتاب«عيار الشعر»ذلك أن الشعر يكون عسيراً على الفهم إذا لم نُحط ببيئته، وطبيعة مجتمعه، وتقاليده، وسننه، ولا ريب في أن تفسير الشعر من خلال الاستناد إلى المادة التاريخية يقدم أطراً متسعة«تساعد المتلقي في فك مغاليق النص، وتضع المصطلح في حدوده التاريخية والاجتماعية».
وفي هذا الفصل توقف المؤلف مطولاً مع الباقلاني، ونظراته لمعلقة امرئ القيس، حيث رأى أن الباقلاني جاء متفرداً في منهجه، وطريقته، وقد نظر نظرة نقدية شبه متكاملة في معلقة امرئ القيس، ولم يكن دارس أدب، بل كان مفكراً عقائدياً، يعكس طبيعة فكر عصره، وأشار إلى أن ملاحظات الباقلاني تركزت على ستة وثلاثين بيتاً من المعلقة، وانصبت على الثنائي الأساسي في كل عمل فني، المعنى واللفظ وقضايا الشكل الفني، وتوقف مع الوحدة الفنية، وسار على مستويين: «الأول الوحدة داخل البيت الشعري، والثاني: تناسب البيت مع غيره من الأبيات».
وختم الدكتور سليمان الشطي هذا الفصل بملاحظة هامة عن جهود الباقلاني، حيث رأى فيها«محصلة متميزة للطريقة النقدية العربية القديمة، القائمة آنذاك، فقد كانت تعتمد على دراسة الوحدة الأساسية في البناء الشعري من كلمة وصورة، وتنظر في مكونات البيت الواحد وعلائقه، بجانب الاهتمام بالملاحظة اللغوية، والسبك اللغوي، وصحة المعنى وشرفه».ص:285.
..الـمعلقات ونظرات العصر الحديث:
في الفصلين الأخيرين من الكتاب توقف المؤلف مع نظرات العصر الحديث للمعلقات، حيث ركز في الفصل السادس على اتجاهين سادا عند دارسي مرحلة الإحياء، هما: الشروح التعليمية، والنظرات الذوقية.
فأصحاب المنهج التقليدي اتجهوا إلى التراث العربي، وسعوا إلى تقديمه إلى العصر الحديث بحلته القديمة، وبعضهم أدخل-ضمن منهجه التعليمي-شذرات من النظرات الحديثة، وقد تطورت شروحهم، واكتسبت ملامح جديدة، عندما تطورت مناهج دراسة الأدب، وهذا ما عبر عنه المؤلف بقوله«ولكن جهود الشارحين تطورت، واكتسبت ملامح جديدة حينما نشطت دراسات الأدب، وتطورت مناهجه، فدخل الشارحون إلى دنيا القصائد السبع والشعر الجاهلي بوجه عام حاملين معهم تراثاً ضخماً من الدراسات والتعليقات والمناقشات التي أثرت الجو الأدبي، ومدت ساحله إلى آفاق عريضة، وعميقة المدى، فلم تعد محاولات للم شتات الآراء القديمة، والتمسك بها بقدر ما أصبحت محاولة للدخول إلى هذه القصائد بالمنظار الجديد الذي لونته هذه الدراسات، وليس من الضرورة أن تكون هذه الدراسات مخالفة لما جاء عند القدماء، فقد تكون حاملة نفس وجهة النظر، ولكنها في طريقة التناول أكثر نفاذاً إلى جوهر القصائد، وأقدر على اكتشاف ما في هذا القديم من جواهر مع محاولة الدفاع عنه، وإبراز إيجابياته» ص: 296 .
ومن الدراسات التي نوه بها المؤلف نظراً لاهتمامها بالمنهج التعليمي في شرح المعلقات مع الاستفادة من تطور الدراسات الحديثة دراسة الدكتور بدوي طبانة المعنونة ب«معلقات العرب:دراسة نقدية تاريخية»، كما ركز على الدكتور طه حسين بصفته نموذجاً للنظرات الذوقية، فهو أحد أبرز الدارسين العرب المعاصرين الذين مثلوها، ولاسيما حينما شرح الشعر الجاهلي، ويصف منهجه بأنه«يمثل ناقداً ذوقياً يعتد بالمنهج العلمي في تحقيق النص، وتوثيقه لغوياً وتاريخياً، وهو في الوقت نفسه دارس أُحكمت ثقافته العريضة فجسد ثقافة عصره، واهتمامات جيله الجديدة، مع ما ترسب في أعماقه من آثار المنهج القديم، ليستوي هذا كله في نفس متذوقة تتموج مع النص تموج إحساس تأثيري مستجيب للنص، ولكن مع وعي من أن يزل الذوق في قاع التقليد، أو يسلم بالفهم السائد إلا عن اقتناع» ص: 307 .
كما ذكر أن منهجه العلمي في تحقيق النصوص ودراستها يجمع بين منهجين:منهج أستاذه سيد المرصفي الذي يعنى بالذوق عناية خاصة في دراسة النصوص القديمة من حيث فقه اللغة، والذوق السليم، والرأي الصادق مع الإكثار من رواية الشعر ، ولاسيما الجاهلي والإسلامي، أما المنهج الثاني فهو الذي استحدثه الأوروبيون في دراسة تاريخ الأدب، والذي يجمع بين النقد التجريبي، والمنهج التأثري، ويشير الباحث إلى أن طه حسين لا يتخلى عن نزعته التأثيرية، بيد أنه يمزجها بكثير من الملاحظات التعليلية النابعة من الأثر القديم الذي شكل أساس ثقافته.
في الفصل الأخير من الكتاب ذكر المؤلف أن أصحاب المذهب الجمالي الذين يعنون بالشعر على اعتبار أنه تركيب لغوي يحفه التفكير الأسطوري، يعتبرون من أكثر الناس اقتراباً من الشعر الجاهلي، والقصائد السبع بوجه أخص، حيث إنه منحهم فرصة نادرة للتطبيق، ويرى أن الناقد الدكتور مصطفى ناصف يعد أهم ممثل لهذا الاتجاه في مجال دراسات النصوص القديمة، ولاسيما منها القصائد السبع، وقد ظهرت جهوده في كتابين أساسيين هما«دراسة الأدب العربي»، و«قراءة ثانية لشعرنا القديم».
فقد ركز في الكتاب الأول على إبراز الخط النظري لفكرته الجمالية، وأقام تصوره على هدم النظرات النقدية المختلفة، وهاجم أصحاب النقد القديم، وبين عجزهم عن مواجهة النص، كما تناول إلغاء التأثير الاجتماعي عازلاً الأثر الفني عن سياقه الاجتماعي، وعن بيئته. وفي الكتاب الثاني أكد نظراته السابقة من الوجهة التطبيقية، فجعله خاصاً بالتطبيق المباشر على الشعر بعيداً عن الجدل النظري.
كما نوه المؤلف بجهود الدكتور كمال أبو ديب التي ظهرت في دراسته الممتازة الموسومة ب: «الرؤى المقنعة»، وأشار إلى أن دراسته هي أبرز وأشهر الدراسات التي اتجهت إلى اختيار المنهج البنيوي لدراسة هذا الشعر، فهي تعد محاولة جديرة بالمناقشة نظراً لما فيها من جهد متميز.
محمد سيف الإسلام بـوفـلاقـــــة * كلية الآداب واللغات ، جامعة عنابة